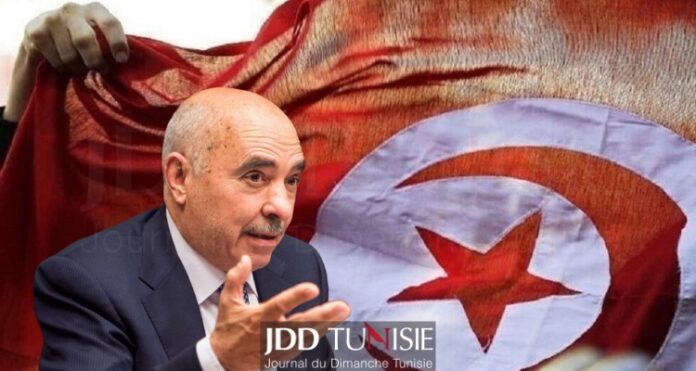بقلم العميد عبد الستار بنموسى
إذا كان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي أصعب من الانتقال السياسي لأنه يتطلب توافقا بين عديد المكونات وتنازل بعضها عن عديد الامتيازات فإن الانتقال الثقافي أشدّ صعوبة باعتباره الضامن الأساسي لإنجاح المسار السياسي والمسار الاقتصادي والاجتماعي وصمام الأمان لتحقيق الانتقال الديمقراطي وترسيخ الثقافة الديمقراطية. ذلك أنه في غياب تغيير جذري للذّهنية في اتجاه ترسيخ قيم المواطنة فإن الديمقراطية التي تهدف إلى الحدّ من تجاوز السلطة وكبح جماحها قصد إنشاء مجتمع حرّ ومزدهر قد تتحول إلى كابوس مروع تمهد له وتعدّه وتنفذه بعض النخب السياسية لتجعل من الديمقراطية أداة طيّعة في خدمة مصالحها الضيقة وأغراضها الشخصية مقابل التضحية بمصالح الشعب الذي لا يمكنه محاسبة الطبقة السياسية عند انحرافها عن أهدافها إلا في محطات انتخابية لاحقة وشرط ان تكون نسبة المشاركة عالية وفاعلة وواعية.
إن الثقافة الديمقراطية تتطلب تجذر الوعي لدى الفئات الشعبية. ذلك أن الديمقراطية لا يمكن لها ان تنمو وتترعرع في بيئة تتفشى فيها الأمية والانتهازية ويروج فيها لإجراءات شكلية تبدو في ظاهرها ديمقراطية وتحمل في طياتها الفئوية والاقصائية والزبونية. إن نضج الممارسة الديمقراطية رهين تمكين الفرد فعليا من التمتع بحقوقه والقيام بواجباته والمشاركة في مختلف الأنشطة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية او البيئية. إن ذلك يستوجب تشبع الفرد بروح الوطنية وبقيم المواطنة وتجذر الوعي لديه.
إن الثقافة الديمقراطية ترتكز على عدّة مبادئ:
• أولها قاعدة المساواة :
التى تفترض إلغاء الانماط التفاضلية المبنية على التدخلات والولاءات واستبدالها بالمساواة الفعلية في الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون وبالقانون. المساواة أولها في الحقوق المدنية والسياسية قصد إلغاء الحاجز بين الحاكم والمحكوم بين النخب السياسية والقاعدة الشعبية وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة بتبسيط الاجراءات وإسداء الخدمات دون تأخير وبكل مسؤولية وشفافية. إن المساواة في الحقوق لا تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية بل تتعداها لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتحقيق العدالة بين الفئات وبين الجهات واعتماد التكافؤ في الفرص. لقد نجحت عديد الدول الديمقراطية في تحقيق المساواة وقلصت الهوة بين الفئات الاجتماعية وبين الجهات لتستفيد الفئات والجهات المحرومة بفضل التنمية المستدامة وبفضل منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهكذا تصان كرامة الإنسان..
• أما المبدأ الثاني فيتمثل في الحرية:
إن الأحرار هم وحدهم الذين بإمكانهم الدفاع عن الديمقراطية والسهر على احترام الحقوق والحريات والوقوف ضدّ التجاوزات التي تصدر عن أعوان السلطة الحاكمة. إن الحرية حتى لا تنقلب إلى فوضى يجب أن تقترن بالمسؤولية فحرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية غيره والحرية تفرض احترام الاخر واحترام الرأي المخالف ونبذ العصبية والعنصرية والفئوية . إن الثقافة الديمقراطية هي وحدها التي تمكَن من بناء مجتمع ديمقراطي توفر الحماية للتنوع والاختلاف في إطار وحدة المجتمع والتوافق بين الرغبات الفردية والمصلحة الجماعية والموازنة بين تعسف السلطة وتطلعات الافراد.
• أما المبدأ الثالث فيتمثل في التوافق عبر ثقافة الحوار:
التي تكون بين كافة فئات الشعب أفرادا ومجوعات نخبا سياسية وقواعد شعبية.
إن الحوار يؤدي إلى بسط الاشكاليات واستنباط الحلول الملائمة تحقيقا للتسامح والسلم. إن ثقافة الحوار لا يمكنها ان تنجح في مجتمع ملؤه الانانية والنرجسية والانغلاق والإقصاء بل تتطلب توفير بيئة تقبل التجدد والتنوع وتؤمن بالانفتاح الفكري والمعرفي وتشجع على الإصداع بالرأى والنقد الصريح في نطاق الاحترام المتبادل. إن ترسيخ الثقافة الديمقراطية داخل أي مجتمع ليس بالأمر الهين لأنه لا يقتصر على النخب السياسية بل يتعلق بالبنية المجتمعية أي بكافة أفراد المجمتع وهي بنية معقدة متعددة الأطياف مختلفة الأهداف مهددة بالمضادات للديمقراطية. البعض يغريه الاصطفاف أو حتى الانحراف. لذلك فإن التكوين الأساسي والمستمر في مجال الثقافة الديمقراطية أمر بالغ الأهمية نحن في حاجة إلى ثورة ثقافية بأتم معنى الكلمة لأن المعالجة السطحية للمشاغل الهامة والمفصلية عبر الشعارات الرنانة والوعود الزائفة والخطب العصماء التي يقدمها السياسيون أثناء الحملات الانتخابية وبعدها كثيرا ما تذهب كالزبد جفاء ولا يجد الشعب ما ينفعه. إن الانتقال الثقافي لا يتحقق إلاّ بإصلاح التربية والتعليم والإعلام وقيام المجتمع المدني بدوره التوعوي الهام وأداء رسالته بعيدا عن المال والترحال وتسّرب خفافيش الظلام. لقد أكدّ دستور 1959 في فصله السادس على مساواة كل المواطنين أمام القانون في الحقوق والوجبات كما ضمن في فصله الثامن حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر. وما انفك المسؤولون السياسيون منذ الاستقلال يؤكدون على أهمية الثقافة ونشر الوعي ومحو الأمية مثلما أعلن الرئيس الحبيب بورقيبة في إحدى خطبه "بأنه قبل البناء بالحجر يجب تغيير ذهنية البشر".
ساهمت المنظومة التربوية منذ بداية الاستقلال في بناء مجتمع مثقف وتكوين جيل يسعى إلى تكريس قيم المواطنة وصيانة قواعدها خاصة لدى الناشئة والشباب حتى تتحول في الممارسة إلى قناعات وثوابت. إلا أن المنظومة التربوية الرامية إلى تأسيس المواطنة شهدت تعثرا وشللا في الواقع وفي ظلّ نظام سياسي غير ديمقراطي لم يقم بواجباته ولم يحترم التزاماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل ساهم في التفاوت بين الفئات وبين الجهات. حيث بقي الشريط الغربي بشماله ووسطه وجنوبه مهمشا ومفقرا. إن عديد العوامل ساهمت في الحدّ من ترسيخ قيم المواطنة مسلكا ومنهجا وأهمها عجز أغلبية السياسيين الفاعلين عن موافقة المجتمع في تطوره خاصة بعد بروز مجتمع مثقف يرنو إلى المشاركة في الشأن العام لكنه يجد الأبواب موصدة أمامه.
ولئن انتشرت دور الثقافة والنوادي الثقافية بكامل أرجاء البلاد وتعددت المكتبات العمومية وقاعات السينما والفرق المسرحية ولجان المسرح فإنه سرعان ما وقع إهمال الثقافة وتهميش المبدعين والمفكرين والفنانين ما عدى من أعلن ولاءه للقصر ودخل بيت الطاعة حيث أصبحت الثقافة مجرد ديكور لتلميع صورة الرئيس والمسؤولين.
لقد أصبح القرار الرسمي يتسم بالنزعة الاستبدادية ويستند إلى الفوقية ويعتمد على وسائل إعلام في أغلبها مدجنة وولائية في ظاهرها بهرجة وإتقان وفي باطنها زيف وبهتان. الأمر الذي انعكس سلبا على المشروع التحديثي الرامي إلى تحقيق حياة مدنية قوامها الإيمان بالمواطنة والتشبع بالوطنية. وهكذا تمّ البناء بالرخام والحجر وتكلّس فكر البشر.
بعد 14 جانفي 2011 سعت العديد من مكونات المجتمع المدني إلى دعم الثقافة وتم يوم 10 أفريل 2011 الإعلان عن ميثاق المواطنة بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة والذي تضمن 16 نقطة أهمها :
• النأي بالإسلام عن كل الصراعات العقائدية والتوظيفات السياسية والإيديولوجية.
• المساواة في المواطنة وفي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• ضمان كافة الحقوق والحريات الفردية وضمان مكاسب المرأة وتكريس المساواة الكاملة.
• ضمان كافة الحقوق المتعلقة بحرمة الشخص وكرامته.
• ضمان حقوق العمل والصحة والتعليم والمسكن لكافة التونسيين وإقرار نظام جبائي عادل.
• الحق في التنمية العادلة بين كافة الجهات وحق الجميع في العيش في بيئة سليمة.
لقد واجه المجتمع المدني بعد ذلك صعوبات جمّة عند صياغة الدستور الجديد وناضل من أجل إقرار مواطنة كاملة دون قيد أو شرط.
إذ انتظمت يوم 13 أوت 2013 مسيرة وطنية قادتها النساء ضدّ صيغة “المرأة مكملة للرجل” الواردة بالمسودة الأولى للدستور.
كما فرض المجتمع المدني عبر نضالاته المتعددة حضوره لأشغال المجلس الوطني التأسيسي عند مناقشة النواب للفصل المثير للجدل وفرض عبر ذلك وعبر الحوار الوطني دسترة المسألة الثقافية نظرا لأهميتها في انجاح الانتقال الديمقراطي. بفضل نضال المجتمع المدني ودور الحوار الوطني ضمن الدستور الجديد لسنة 2014 في الفصل 31 حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر وأكدّ بأنه لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على تلك الحريات كما ضمن في الفصل 42 الحق في الثقافة وحرية الإبداع.
إلاّ أن تلك الأحكام الدستورية لم تفعّل ولم يتغير واقع الثقافة إذ حافظت وزارة الثقافة على نفس نمط العمل داخل مؤسساتها وإداراتها وعلى نفس التصور الذي تشوبه إخلالات عديدة فأصبحت دور الثقافة تخضع للتجاذبات السياسية والحزبية.
إن الانتقال الثقافي لا يتحقق إلاّ بتغيير الذهنية ونشر الوعي عبر إصلاح المنظومة التربوية وإصلاح منظومة الإعلام.